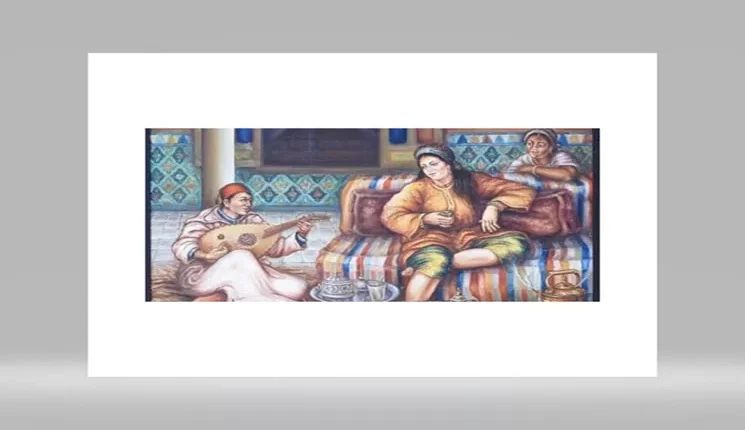
القصّة القصيرة.. البداية والتطور
حسن بولهويشات
غطّى الحضور القويّ للشّعر خلال العصر الجاهلي على الإشراقات الأولى لفن القص التي تشكّل بموازاة القصيدة التي حازت على مكانة رفيعة داخل نظام القبيلة العربية، وذلك حين استطاع الشّاعر الجاهلي أن يصوّر جمال البيئة والطبيعة العربية ويُشيع أخبار وأمجاد وانتصارات القبيلة، حتى صار لكلّ قبيلة شاعرها الذي تفخر به بين القبائل الأخرى. وقد أقيمت مجالسٌ وأسواقٌ للشّعر تبارى فيها الشّعراء في إلقاء قصائدهم فبرعوا واستطالوا، كما هو الأمر في المعلقات الذي حظيت بشهرةٍ واسعة. وهي أمورٌ كرّست حضور الشّعر فصار «ديوانَ العرب» بلا منازع، وأشاحت الانتباه عن أشكال التعبير الأخرى، بما في ذلك فن القصة.
من جهتنا، يمكن تتبع وتلمّس هذه الإشراقات في ما توفّر لدينا من أخبار القبائل وقصص الشخصيات التي يتشابك فيها الواقعي بالخيالي، كما هو الأمر في سيرة حياة الشّاعر عنترة بن شدّاد وعلاقته بمحبوبته عبلة. وأيضًا قصص الأساطير والوقائع التي تناقلتها الألسن وتفنّن الروّاة في تدويرها بين القبائل وفي المجالس الأدبية، بغض النظر طبعًا عن الاختلاف حول أسبقيّة الشعر والنثر عند العرب. بل إنّ القصيدة الجاهلية نفسها حفلت بقصص تتحدث عن أيام الحروب وما رافقها من انتصاراتٍ وانتكاسات، وعن ملوك الغساسنة والمناذرة، وعن الكهّان والجنّ والعفارين. ولو أن هذه القصص شفهية في الغالب ولا تسمو إلى فنّ القصة بالشكل المكتمل الذي عليه الآن، وبالمقوّمات الفنيّة التي ظهر بها في الغرب. غير أنّ وجودها يؤكد على أمرين: الأول أن منشأ القصة العربية هو الجزيرة العربيّة، وهو ما تؤكدّه الشواهد الكثيرة في قصص القرآن الكريم، مثل قصّة آدم عليه السلام وقصّة أهل الكهف. والأمر الثاني هو أن هذه القصص هي التي شكّلت البذور الأولى للقصّة العربية الحديثة، وبصمت على أصولها العربية، وعلى عكس القصة القصيرة بشكلها المعاصر التي هي إنتاج أوربي خالص.
عودة إلى الإشراقات القصصية الأولى، والتي ظهرت مع بداية الإسلام حيث احتوى القرآن الكريم على قصص الأنبياء وسيّر حياتهم التي حفلت بالعِبر والدروس. وألهمت الكتّاب خلال العصر الأموي فتنوعت القصص بين الدينية والتاريخية والفكاهية، مع استفادة واضحة من تطوّر الكتابة النثرية على يد كتّابٍ مرموقين، أمثال عبد الحميد بن يحيى، المعروف باسم عبد الحميد الكاتب الذي عاش في القرن الثاني الهجري. تأتى ذلك بالموازاة مع القصّة العربيّة التي نبتت في بلاد الأندلس مستفيدةً من الظروف المناخية والاجتماعية الجديدة ومن ازدهار الحكم الأموي، ومن سحر عناصر الطبيعة؛ من أنهار وحدائق وسهول شاسعة. ويحفل كتاب «طوق الحمامة» لصاحبه ابن حزم الأندلسي بالكثير من القصص التي تعكس نوع الكتابة السردية والقصصية الذي كان سائدًا بالأندلس ومن دون أن ينسلخ كليًا عن نوع القصة بالمشرق. وبالرغم من أنّ قصص الكتاب تصبّ كلّها في اتجاه الحب، فإنها تقدّم، على الأقل، صورة كافية عن الخيال القصصي في بلاد الأندلس أيام حكم الأمويين.
وصعودًا في الزمن، عرف فن القصة منعطفًا مهمًا في العصر العباسي بفضل نشاط حركة الترجمة وازدهار الحياة الاجتماعية والفكرية والأدبية، إذ تأثرت القصّة بالتنوع الاجتماعي واللغوي، خصوصًا مع تعايش العرب والفرس في بيئة واحدة، وهو ما انعكس إيجابًا على الكتابة القصصية التي حبلت بقيّم التسامح وروح الانفتاح على الآخر وعلى تنوّع العادات بالنسبة للقصة العربية، وبتنوع الموضوعات والتجديد في تقنيات السرد بالنسبة للقصص المترجمة عن الأمم الأخرى، مثل «كليلة ودمنة».
وقد استفادت القصّة العربيّة من فنّ المقامة الذي ازدهر في النصف الثاني من القرن الرابع الهجري مع بديع الزمان الهمداني مؤسس هذا الفن. ثم في ما بعد الحريري الذي طوّر كتابة «المقامة»، والتي تتقاطع مع القصة القصيرة في الكثير من التقنيات الكتابية. بل إنّ المقامة هي فن نثري بالأساس، وتروي قصّةً أو حكايةً على لسان الراوي الذي قد يكون هو بطل القصة أو ممن عاشوا أحداثها في زمنٍ معيّن وفي مكانٍ حقيقي أو متخيل. وهو التعريف الذي يحشد جميع مقوّمات القصة، ويؤشّر على أنّ الانطلاقة الحقيقية للقصّة العربية تأتّى بفضل نصوص المقامات خصوصًا «مقامات بديع الزمان الهمذاني» و»مقامات الحريري». كما أنّ هذه النصوص المقامية تشي ببداية استقلال القصّة القصيرة عن باقي أصناف التأليف الأدبي، وهو ما يذهب إليه الناقد شكري محمد عياد في كتابه «القصة القصيرة في مصر- دراسة في تأصيل فن أدبي»(1968).
الملاحظ من خلال هذه الكرونولوجيا السريعة، أن فن القصّ كان موجودًا عند العرب بموازاة وجود الشعر، غير أنّ هذا الوجود كان تحت عدّة مسميات كالمقامة أو مدسوسًا في تجاويف أشكال تعبيرية نثرية أخرى كالرسائل ودروس الموعظة والإرشاد. فضلًا عن قلّة هذه القصص وشُحّها، وهو ما يفرض على الباحث صبرًا وأناةً لاقتفائها في بطون الكتب التراثية. ونلاحظ، أيضًا، أنّ البحث في الرواية العربية الحديثة وأصولها لا يكتمل موضوعيًا في ظل إغفال وتجاهل هذه النصوص التراثية التي تُؤصِّل النص الروائي العربي الحديث. وهذه هي المنطقة البحثية بالتحديد التي يتحرك فيها درس السرديات العربية، كما هو الحال مع مشروع الباحث سعيد يقطين وطلّابه في الجامعة المغربية. ونكتفي بالإشارة إلى كتابه «الرواية والتراث السردي: من أجل وعي جديد بالتراث»(1992)، حيث يبرز يقطين تعلق نصّ الرواية بالنص التراثي؛ أي تعلق النص اللاحق بالنص السابق.
وتسمح لنا الفقرات السابقة بالتمييز بين الرواية العربية الحديثة التي استلهمت مادتها وتقنياتها، بنسبٍ متفاوتة بين نصٍّ وآخر من النص القصصي التراثي ومن النصوص الروائية الكلاسيكية في الأدب الفرنسي والأدب الانجليزي. وبين الرواية العربية المعاصرة التي تأثرت بالقصة القصيرة المعاصرة والتي يبدأ تاريخها بالاحتكاك بالغرب وترجمة القصص، وانتشار الصحف اليومية وكتابات المهجر، ونشاط حركة الترجمة. بل إن روّاد القصة العربية هم الذين سيبادرون بكتابة النصوص الروائية الأولى، وهي المسألة التي تطرق إليها يحيى حقي في كتابه «فجر القصة المصرية»، بكثير من التفاصيل التي سَبقت مرحلة تطوّر الرواية العربيّة.
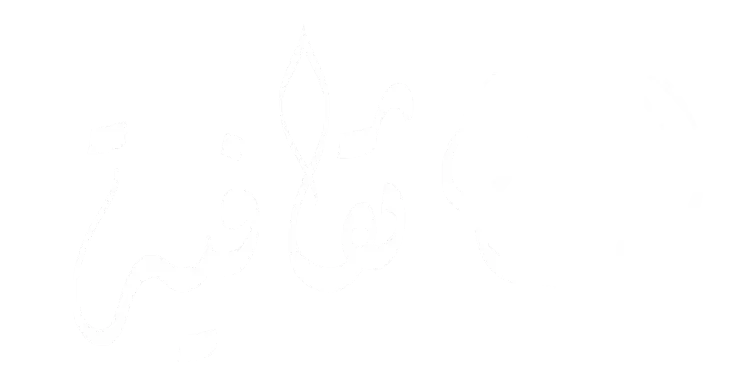
 ثقافية
ثقافية