
محكيات .. مَلَائكةٌ وقَمْلٌ (مِنْ سَرْدِيَّاتِ الصِّبَا)
جواد المومني
اَلْفردُ منا، بتكوينه الذي هو عليه، مُشَكَّلٌ من ترسُّبات وتفاعلات، ظاهرية وخفية، وإن استقصينا تَبَدَّت أمامنا تراكمات سابقة بِحُلوها وبمرها، هي التي شيَّدت الصَّرح الماثل. ولعل أولى صِداماتنا مرتبطة بعالم المَدرسة، حيث دهشةُ البدايات و الاغترابُعن رحِم الأسرة.
شخصيا، وربما على نقيض أقراني من جيلي السَّبعيني للقرن الفائت، لم ألج أبدا بوابة «المْسِيد/المسجد» بوصفه خطوة أولى من التعليم الأولي. رغبةُ السيد الوالد اقتضت خِلاف السائد؛ لست أدري سببا لذلك وقد كنت بِكر أبنائه، حيث سَيسري نفس القرار على من أتى بعدي. وأذكر أنَّ جَدِّي حاول قدر مستطاعه تغيير رأي الوالد، دون جدوى.
سيكون شهر أكتوبر عام 1972 صبيحة أحد أيامه، نقطة تحول بالنسبة لي. فعلى طول ساحة المدرسة الابتدائية، كنت ممسكا بيد والدي، إلى جانب المدير، خائفا متوجسا، ومتهيبا من اللحظة ، كمن يُقاد إلى مقصلة أو غرفة إعدام. لا أحمل شيئا بيدي، ومتسائلا عن معاني: الدراسة، المدرسة، التلاميذ و المعلم! هل سيتم نقلي إلى عالم جديد، غريب، قبيح، ظالم، قاس، بلا شفقة، أم العكس؟؟ كنت جاهلا حقا المصير الذي ارتضاه لي والدي. أحقا سأحقق قفزة إلى ضفة مغايرة، أصير فيها «رَجُلا» كما قيل لي ؟ هل كبُرت ونضجت بما يكفي حقا إلى درجة أني سأقوى على مجابهة العاتي من الأيام؟!
بدا لي فضاء الحجرة وقد أقبلت عليه، فصلا من جحيم! كانت ظلمة المكان ترخي علي ميلا نحو البكاء، وكانت مُتَّشِحَة بهالة مُغبَّشة : جدران شاهقة، طاولات مصففة، صور مختلفة، لوح أسود و معلم بِسُترة بيضاء؛ أما عيون الصغار أقراني، فقد حسبتها و كلها مثبتة نحوي، قادما جديدا، نارا متقدة ستحرقني. لم أكد أستوعب اللحظة حتى أخذني المعلم من معصمي وأقعدني في مكان شاغر، تَخيلتُني وأنا أُجالسُ وجها غريبا (بل وُجوها غريبة)، أن حصة التعذيب ستنطلق!! كان قلبي الصغير منقبضا. حين غادر والدي والمدير قاعة الدراسة، وتركاني لمصيرٍ، سيشكل بالنسبة لي أحد أهم المنعطفات المؤثرة في حياتي… إلى الأبد.
أذكر أنني كنت أُشَخْصِنُ كلَّ المُعجم الجديد الذي يدخل عقلي. فحين يقرأ المعلم كلمة (بُكْرَةً) أخالُها بِنْتا بظفيرتين، أو حين ينطق (النَّجاح) أعتبره رجلا بلحية كَثة وشعر طويل مسترسل، وحتى لفظة (العطلة) تصورتُها محيطا عظيما من الفراشات البيضاء !! لست أدري كيف سَوَّغ لي عقلي الصغير ذلك؟!
لكن أمرا غريبا ظل منحوتا في ذاكرتي وما غادرها قط؛ كنت حسبت أن مجموعة من الملائكة المُجنَّحة (وهي المخلوقات المجبولة على الخير) قد أذْنبتْ في حَقِّي، حينما تكلفت بإنجاز فعل مذموم، إذ تأتي ليلا (و لست أدري كيف تدخل البيت وأبوابه موصدة!) خلال نومي، و تقوم بوضع/زرع عدد من أعشاش القَمْلِ في فروة شعري!! بالغد، تشرع أمي في فَلْيِ رأسي لأنني أحُكُّه بشراسة، ثم تضع فيه مَراهِمَ صيدلية وخلطات أعشاب شعبية مضادة، لكن الأمر ما يفتأ يتكرر. طبعا لم يفطن والديَّ للسبب الحقيقي، إلا بعد أن استشرى الوضع وعمَّ كل تلاميذ المدرسة، بدون استثناء، حيث شرعت الإدارة في التصدي، برش الرؤوس بمبيدات مضادة لتفشي القمل، خلال فترات زمنية متقاربة قصد التغلب على الحالة.
الحديث عن عوالم المدرسة، مرتبط مباشرة بالقوانين الضابطة داخليا، من بينها ارتداء الزَّي الموحد (الوزرة البيضاء) .. أذكر أنني تمردتُ على حملها و لم أكن أُطيقها، اعتبرتها عبئا !! ورأيت فيها شبها بالطباشير المستعمل في الكتابة. و قد شجعني على الفعل، والدي، الذي انصاع لرغبتي، هو الذي كان مُعَلِّماً جديدا انتقل للعمل بنفس المؤسسة، نفس الموسم الدراسي. و للتاريخ، أقول: خلال عمري، لم أضع على جسدي الوزرة البيضاء إلا مرة واحدة، عندما استلفْتُها من أحد تلاميذ الفصول الأخرى وارتديتها بغاية أخذ الصورة التذكارية الجماعية للقسم !! و نفس الأمر استمر طيلة مشوار حياتي المهنية أيضا !
مِن أجمل ذكرياتي بالمدرسة، فترات العطل. فترتئذ،كانت المؤسسات التعليمية تَتَعَطَّلُ لمرتين خلال الأسبوع: الجمعة و الأحد. أما ما كان يروقني أكثر ويستهويني، فهما ليلتا اليومين (الخميس و السبت) حيث كنت أعود إلى بيتنا فرحا، ممسكا غالبا بِكيسَيْ (زريعة) [حبات نوار الشمس] ولطالما خلقت أجواء سعادة فردية أو ثنائية، رفقة زميل عائد هو أيضا للمنزل، إلا أن ذلك لا يستمر غالبا، حينما يُذَكِّرُ أحدنا الآخر بأن يوم غد مخصص لأعمالٍ بفضاء المدرسة، حين يتم تكليفنا بالحضور الضروري إلى الساحة قصد إنجاز أعمال مختلفة كثيرة، منها: التشجير والبستنة، كنس الممرات، تنظيف الحجرات، غسل مكاتب المعلمين، ملء المحابر بالمداد (الأزرق و الأحمر) ، حرق أوراق سلة المهملات، المسح الجيد للسبورات، تجديد الأغلفة المهترئة للدفاتر والكتب، إعادة تصفيف كتب ومصنفات ومؤلفات مكتبات الأقسام، استبدال طواقم رؤوس أقلام الكتابة بالحبر… كان ذلك يتم بكل تفان ورضا، ولم يكن يستطيع أحد تجاوز طقوس الحياة المدرسية أو التجرؤ عليها؛ فالانضباط كان جماعيا لفترتَيْ وَضْعِ المراهم في العيون، أو التطعيم (التلقيح) ضد أمراض متفشية !! و ليس من حق أي أحد التغيب، كما لو أن الأمر واجب عسكري !
أما صورة المعلم، فهي مرتبطة مباشرة بالعصا. هو عنف مادي بالنهاية، غالبا ما اسْتَحْسَنَهُ أولياء الأمور. حِصصُ استظهار آيات القرآن، أو جداول الضرب والقسمة، أو نصوص المحفوظ الشعري، غالبا ما تتحول لحصص التعذيب و بشتى أنواع آلياته. وتَحضُر ذاكرتي أحيانا مَواقفُ، يَصعُب عليّ وصفُها أو تَصنيفُها أو الحُكم عليها، خصوصا إذا مرّت عليها السِّنُونُ الطِّوالُ المَديدةُ. مِنْ ذلك، يومٌ عَصيب و عنيف جدا على جسدي!
أتذَكر بشكل دقيق لحظةً خلال سنة 1974، و أنا تلميذُ الإبتدائيّ بالمستوى الثالث، في حصةٍ مسائية، عند مُدرّس اللغة العربية، كان الجو مَطيراً باردا، والفِقرةُ مُخصّصَةً للإملاء بالكتابة على الألواح، المادة المُستَهدَفة كانت العدد (مئة/مائة)، لكني وبشكلٍ تلقائيّ، بعد أن أمْلَى المعلم لفظ (100) رقماً، خططتُه على لَوْحِي حُروفاً هكذا: (مئة) ورفعتُه. تَفحّص المدرس جيداً في المكتوب ثم أمَرَني بالتقدم نحوَه. لستُ أدري، هل راقب كل الألواح أمِ اكتفى بي فقط؟! و هل استهدفني دون غيري؟! أخرَج عصا، كان يَحتفظ بها في درج مكتبه، و انهال على راحَتَيَّ الصغيرتين بضرباتٕ قوية موجعة لمرات عديدة و هو يصرخ: ( لفظ «مئة» … نكتب الهمزة بعد الألف يا حمار ! )
الآن … و بعد مرور نصف قرن على الواقعة، يَحزّ في نفسي ما حصل لي، مادامت همزة العدد (100) يَصحّ فيها الوجهان !!
سامحه الله…. وفي ذاكرتي غصّة !!
ومن جميل اللحظات داخل فضاء المؤسسة، أن التدريس كان يتم وسط روائح الطهي و نكهاته و توابله، القادمة من مطبخ «الداخلية» . فغالبية التلاميذ المتمدرسين كانت تنتسب للقرى والمداشر المتاخمة لحدود المدينة، و كان يتم توفير مطاعم و مَآوٍ لها في إطار المساعدة الاجتماعية.
بالنسبة لي، لم يكن يَعنيني ذلك، لكنني كنتُ أتُوقُ لعيش تلك اللحظة/اللذة. وقد تَدَخَّل والدي لصالح تحقيق تلك الرغبة. عِشتها بكل جارحة، بمحبة وغبطة. وسُرِرت عندما تَدَبَّرَ لي والدي حصة غذاء بالمطعم. وُضِعَ أمامي، كغيري، صحن زجاجي من العدس مع قطعة خبز وجبن، وبرتقالة ثم كأس شاي. كان الأمر جميلا. لست أدري لِمَ أحببتُه؟ هل تضامنا مني، أم تذوقا لمجهول؟ أَحُبَّ معرفةٍ واستطلاعٍ أم كان شيئا غيره؟ لكني بالنهاية تَمنيتُ تكرار اللحظة، خصوصا و قد اختار لي الحارس العام المكلف مقعدا إلى جانب فتاة شقراء. معا، تبادلْنا نظراتٍ غريبةً. أذكرأننا تبادلنا أيضا بعض «الهدايا»…من جَيبِ سُترتي، أخرجتُ حُبيبات (الزريعة) ، وضعتُها فوق الطاولة أمامها دون كلام، ومن جهتها، أخرجَتْ من محفظتها قطعة (زَمِّيتة) ملفوفة في كاغد، تتناثر منه بقايا السكر، جعلتْها أمامي. تَباسَمْنا. انشغلتْ هي بتناول وإكمال وجبة غذائها، بينما أنا، رحلتْ بي أحلامي الطفولية الصغيرة، صوب حُقول قمحٍ بأمواجٍ من السنابلِ المُتمايلة، وفي الأفق، ترتسم أشعة شمسٍ تُقارب غروبَها، بكل حُنُو، على طَيْفَين صَغيرين.
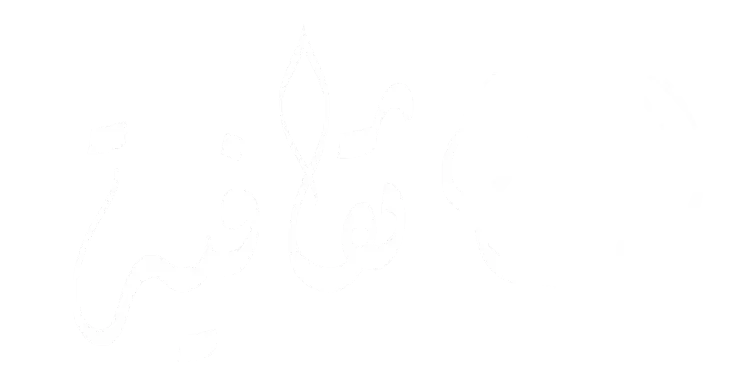
 ثقافية
ثقافية