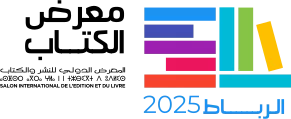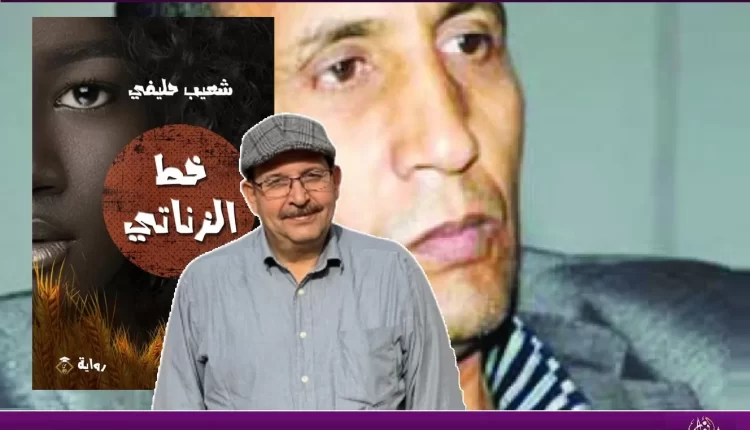
العالم من نظرة واحدة: قراءة في رواية “خط الزناتي” لشعيب حليفي
-
حميد ركاطة (°)
سيلاحظ القارئ لرواية “خط الزناتي” للأديب شعيب حليفي، لا محالة أنه ظل وفيا لوسطه، ومجاله الجغرافي الباذخ الشاوية، حيث يدهشنا بلمسته الساحرة، وهو يحقق قفزة نوعية على مستوى الكتابة، من خلال ارتكازه على كتابة بالحواس، إلى جانب اعتماد كتابة بصرية ساهمت في نحت اللغة الواصفة، وأمدتها بالكثير من المقومات المتميزة.
ترصد الرواية الواقع البائس والصعب، لشخصيات من بدو الشاوية، مغلوبة على أمرها، تعيش حياة قاسية، وترغب في الانعتاق، لتحسين ظروفها، لكنها لم تستطع أن تحقق مرادها، وهذا ما رصدته الرواية خلال أربع وعشرين ساعة، وإن كانت الأحداث التي ساهمت في تأثيث معمار الرواية تتجاوز هذا الوعاء الزمني بكثير. بفضل الاسترجاع، والتذكر، والرصد وهو ما نفح أحداثها بالكثير من القصص، وأمدها بحقائق التخييل الذاتي. ومكنها من قنوات خاصة سردت فيها الحكايات ليلا، ونسجت تفاصيها الباذخة من رحم خيال جامح.
ولعل الارتكاز على سرد تفاصيل يوم الحصاد العصيب وحيثياته المرئية واللا مرئية، نفحت الرواية بأنفاس أوهمتنا بواقعية أحداثها، وبتنوع شخصياتها (حيوانات، طيور نباتات، حشرات، أليات، أشخاص) وقد بلغت طبيعة العلاقات بين بعضها حد الانصهار، سواء أثناء العمل، أو أثناء السهر.
والسارد يعرض علينا تعاقدا زمنيا داخل دورة يوم واحد، يبدأ مع تلاشي غبش الليل، وبداية اللحظات الأولى للفجر. وينبهنا بكون كائنات الرواية “تمارس اختياراتها بكل حرية، وعن طواعية، وبكل أمانة ومسؤولية، وهي من قررت الخروج من الواقع بشكل جماعي، والهروب نحو الرواية لموصلة العيش فيها”، وهذا سيدفعنا إلى التساؤل عن أسباب هذا الهروب الجماعي، فهل ضاقت بها سبل العيش في الواقع إلى هذا الحد؟ ثم كيف يمكننا تعليل هذا النزوح داخل نص روائي يتعاقد معها على دورة يوم كاملة، من الفجر إلى الفجر، بينما تكشف فصول الرواية عن أزمنة أبعد من ذلك؟
لقد اعتمد في تقديم الأحداث عبر تقسيم يوم الحصاد، إلى ستة أجزاء زمنية:
تبدأ مع الساعات الأولى للفجر”ساعة الفجر.. يتلاشى الليل..”
شروق الشمس: “يوم حصاد ابتدأناه مع شروق الشمس”
الظهيرة: “حلت الظهيرة ملتهبة في العراء وظلالها المتفرقة”
العصر: يزحف العصر بلا رجلين محاكيا آلة الحصاد”
الغروب: الشمس تتدلى كأنها دلو مثقل بالحمم في بئر مهجورة بلا قعر”
الليل: خبا ضوء النهار، وعادت الروح إلى سكينتها تلملم ما تستر به نفسها من نور الليل الأشد لمعانا”
الفجر: “هذه آخر أنفاس ليل يغرق بلا صخب في بحيرة غامقة اللون، ثم يستسلم ويترك الخيوط البيضاء الحليبية تغزل السدى للنهار”
وتم التعبير عن الزمن بأحاسيس متضاربة تفاوتت من حيث التوظيف، بين الاستعارة والتشبيه، بتوظيف أسلوب شاعري أحال على إحساس عميق، من قبيل:
الليل سلطان بربري بسلهام أسود- مر النهار طويلا مثل راعي إبل وحيد- الليل مسمول العينين- ، أخشى أن يسرقوا الليل كما سرقوا النهار” – الحياة يوم واحد من صفحات كثيرة، كما تم توظيف أسلوب آخر ينم عن خشونة و قسوة من قبيل: “ماذا لو تهدم الجسر واستمر الليل” – هرول الفجر سريعا، حلت الظهيرة ملتهبة ، تتدلى الشمس كأنها دلو مثقل بالحمم الغروب القاسي.
كما تم تناول مفهوم الزمن من خلال زوايا نظر أخرى، كشفت عن الرغبات الدفينة، والهواجس الخفية.
“تمنيت أن تكون لي نظرته -طائر بوصرندال- وأنا أنظر إلى الزمن”
الزمن مأوى الأسرار الهاربة في بحثها عن كهوف ترقد فيها أحلام تهفو للعودة إلى الحياة”، ” الزمن يتغذى على أعمارنا للحياة”، ” أنا الناموس.. أريد تغيير نفسي”، الليل مفتاح النهار والنجوم ملاذ التباريح”.
المكـــــان
في حين شكل المكان حقل حصاد بالنهار وضيعة بالليل، بها بئر، ومنزل تمت الإشارة إلى صالة كبرى فيه، استعملت كمكان لإقامة الاحتفال السنوي. مع الحديث عن أماكن أخرى، كالنفق أسفل القنطرة الآيلة للسقوط.
الفشل في الحب وفي الحياة والمعاناة هي القاسم المشترك بين شخصيات الرواية
الصور المفارقة داخل الرواية
ويمكن رصدها من خلال حوار الحيوانات فيما بينا، بحيث نسجت خطابا يتجاوز حدود الواقع، وخصوصية النوع كما هو الأمر بالنسبة للكلاب، وجنحت بنا نحو العجائبية والغرائبية، واستطاع السارد أن يكرس هذا الفعل كخطاب مألوف، يمتلك اواليات التبليغ ويضع صاحبه على نفس المسافة من غريمه. كما حدث بين موسى الزناتي والكلب الكرطيط، ونستشف من الحوار نوعا من التعالي، والمفاضلة، والكلب الكرطيط ينحت لنفسه مكانة أعلى من مكانة عيسى الذي فرط في حب الرحالية، والراعي الحيمر الذي تخلى بسهولة عن بنت دويدة. كما كشفت عن مؤهلات خارقة، باعتبارها كائنات تمتلك القدرة على قراءة الخط الزناتي، ولها إمكانات للرؤيا تضاهي قدرة باقي المتواجدين بمحيطها، نقل السارد بعضا منها، وجاءت على شكل متوالية بديعة. ضمن مشاهد مسرحية:
المشهد الأول:
عندما سخر الكلب الكرطيط في حواره مع الكلبة سوسو، من عيسى الذي فرط في بنت دويدة، والراعي الحيمر الذي فرط في الرحالية. مطاردة الراعي وعيسى للكلب، فتطايرت حبيبات التراب مفزوعة وقالت” عسى الله أن يأتي بريح تأخذكم وتترككم معلقين”
يخاطب الراعي حبيبات التراب: ألم تسمعي ما قاله الكرطيط؟
عقبت الحجارة على عيسى الذي كان يحملها في يده”(..)الكرطيط ليس عدوكم ولا عدوي. ابحثوا عن أعدائكم في أبناء عمومتكم”، وقد تبرأت من اقحامها في حرب ليست بحربها
عيسى للحجر: هل أنت مجنون !! متى كان لك قلب تحس به أيها الحجر. لقد تجاوزت ما هو مسموح لك به”/ وسيرصد السارد دهشة بقية الكائنات” قلت لهم جميعا وقد عادوا: كل ما قيل.. خروج عن صفحة الليل..”
المشهد الثاني:
حوار القنفذ مع الراعي
“هل تعرف أني سأكون مع من كنت تتمناها زوجة لك، بنت دويدة. تعال وتفرج علينا أيها العنين. انتهى الكلام، وارتاحت مدام!!
المشهد الثالث:
تعقيب القنفذ على حديث الفقيه الحمادي والشيخ البرغوث
“لن أصمت حتى يركب القنفذ الحمار”
غمغم الحمار بالنهيق/ أسرعت سوسو بالنباح في وجهه/تدخل العطار محتجا، نعت الكلبة بالقنجيرة/ علا نباح الكلاب من خارج الضيعة مؤازرة الكلبة سوسو/ دخول موسى والعطار في ملاسنة / تكسير الراعي الحيمر للمشهد بعزفه على المزمار على إيقاع عيساوي/ انقطاع موسى وخيرة عن العالم.
وقد عقب موسى الزناتي على ما كان يحدث حوله، بعدما لاحظ دهشة خيرة الكناوية، التي طلبت منه أن يعلمها السحر، وعدم استيعابها لحقيقة ما كان يفعل. لم أشأ أن أخذل خيرة وهي التي تعتقد أني أعرف ألسنة الطيور والحيوان وأحاورهم، وأن سوسو تكلمني وأكلمها، وأنها ليست كلبة مثل كل الكلاب، وإنما وعاء يأخذ في كل مرة، الروح التي أريد أن توافق مزاجي”
المشهد الرابع:
تم توظيف السخرية عبر تمريرها من خلال الضحك، للتعبير عن أسرار الذيل، يقول السارد وهو يقدم لنا لقطة منفلتة من عقال زمن هارب. الكلب الكرطيط.. بعدما انتشى بنصره وهو عائد من معركته، عندما رفع نظراته نحو سوسو، هم بتحريك ذيله، فتوهم ثانية أن له ذيلا، لكنه سرعان ما انتبه أنه فقده في معارك سابقة لا يذكرها.. فشرعت سوسو تضحك”
وستشكل هذه اللقطة بإحالتها الزمنية، نواة لتمرير مفهوم السخرية، ونقطة انطلاق بناء صورة أكبر، يمكن إبراز تشكل مشاهدها بالتدريج كما يلي:
اللحـــظة
-
الكلبة سوسو” التقت عيناه الذاهلتان بعينيها المنفلتتين، فشرعت تضحك
-
بلغت عدوى الضحك باقي الكلاب الأخرى في الأقاصي فصارت تضحك وتضحك
-
وضحك عويسا وفاطنة زوجه والرحالية صاحبته،
-
تحول هدير الجوندر إلى ضحك
الانتقال من اللحظة إلى ساعة من الزمن
بعد ساعة سيصل الضحك المدينة، فيضحك الآدميون ضحكا لا منقطعا
-
يطول راكبي القطارات والحافلات المتوجه إلى باقي المدن، وكذلك الترامواي والباصواي وسيارات الأجرة والتريبورتورات والكراويل، وكل ما يدب بإحساس.
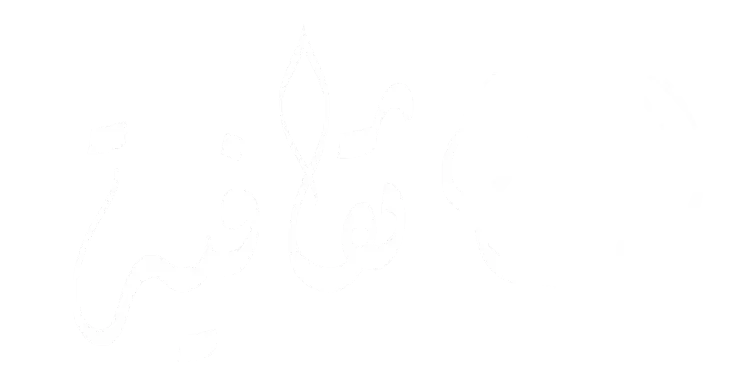
 ثقافية
ثقافية